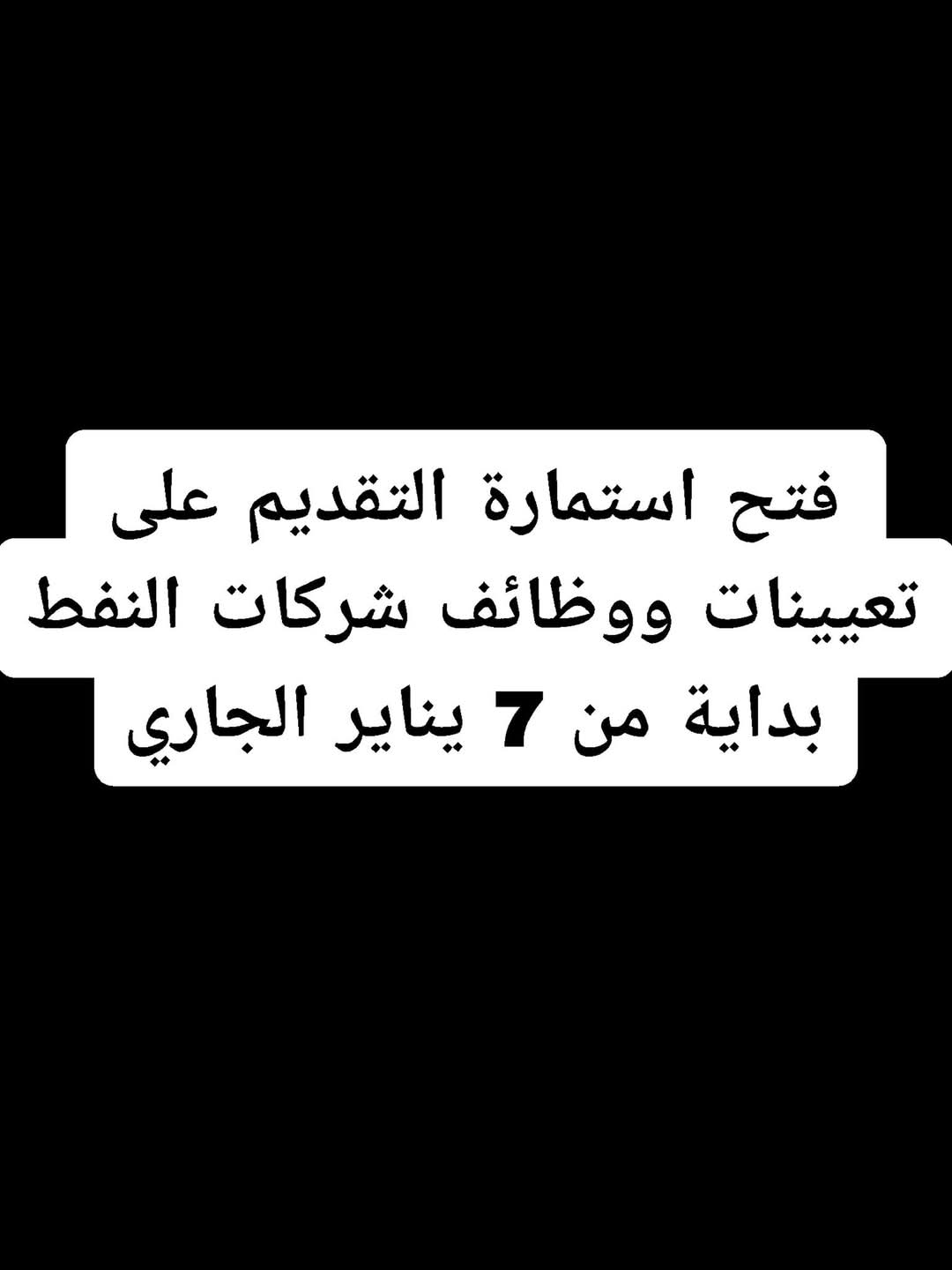ليلة غيرت علاقتي بعائلة زوجي للأبد – كاملة

عدتُ من رحلتي قبل الموعد بيومٍ واحد.
فتحت باب البيت فاستقبلني صمت غريب… ليس الهدوء المعتاد، بل ذلك الصمت الثقيل الذي يشعر به المرء قبل اكتشاف خطأٍ كبير.
ناديت:
“ليلي؟”
ولا تزال حقيبتي في يدي.
ظهرت صغيرتي ذات التسع سنوات عند مدخل المطبخ، حافية القدمين، وقطعة قماش مبتلة بين يديها. كانت وجنتاها محمرّتَين من شدة الفرك، ورائحة المبيّض تملأ المكان. الأرض كلها مبللة، والدلو بجانبها مليء بماء متسخ.
قالت بصوت منخفض ودهشة في عينيها:
– ماما؟ رجعتي بدري؟
نظرت إليها، ثم إلى ركبيتها، ويديها الحمراء، وكتفيها المرتجفين.
كانت الساعة تشير إلى 7:42 مساءً.
سألتها بصوت هادئ لكنه حاد كالسيف:
“فين تيتة وجدو؟”
خفضت رأسها وقالت بخفوت:
– راحوا الملاهي… مع إيميلي.
تجمّد شيءٌ ما داخلي.
إيميلي… حفيدتهم “الحقيقية”، كما اعتادوا المزاح عندما يظنون أنني لا أسمع.
اقتربت منها وسألتها بلطف متماسك:
“وليه يا حبيبتي بتنضّفي الأرض؟”
ترددت قليلًا، ثم تمتمت والدموع تلمع في عينيها:
– تيتة قالت إن ده عقابي… عشان كسرت طبق. والله ما كنتش أقصد يا ماما…
قاطعتها فورًا، ركعت أمامها، أمسكت وجهها بين يديّ:
“بس خلاص… يا قلبي، خلاص.”
مررت أصابعي على شعرها المبلل، ورأيت كيف كانت تخفي يديها الحمراء خلف ظهرها من شدة الخجل والألم.
وقفت وسألتها بجدية:
“طب… إمتى مشوا؟”
– بعد الغدا.
“يعني كنتِ لوحدِك كل بعد الظهر؟”
– أيوه.
هنا لم أشعر بغضب عادي… بل غضب بارد، كثيف، صامت.
هؤلاء الذين ترجّوا أن يساعدوني أثناء سفري.
هؤلاء الذين يعيشون على بُعد شارعين فقط.
فتحت هاتفي فلم أجد رسالة واحدة… ولا مكالمة فائتة.
وجدت فقط منشورًا من حماتي — صورة لإيميلي في الملاهي تأكل غزل البنات، وتعليق يقول:
“يوم الجدّ مع فتاتنا المفضّلة ❤️”
أغلقت الحنفية، جففت يدي، ثم التفت إلى ليلي وقلت بنبرة لا تقبل النقاش:
“يلا يا حبيبتي… لمّي شنطتك الصغيرة.”
نظرت إليّ بخوف وسألت:
– هنمشي؟
“أيوه، يا روحي.”
لم تسأل إلى أين…
فالخوف الفطري لدى الأطفال يُخبرهم عندما يحدث شيء كبير.
وفي صباح اليوم التالي، كان هاتفي يشتعل بالمكالمات:
اتصالات… رسائل… مكالمات فيديو…
لكنني لم أُجب.
لأن القرار كان قد اتُّخذ.